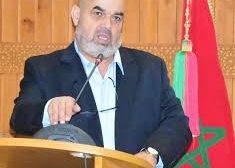محمد بوبكري
يؤكد تطور العلوم الإنسانية والاجتماعية أن النزعات القومية والطائفية قد فقدت كل مبرراتها في عصرنا الحالي، حيث صار تمجيد الانتماءات القومية والَقبَلِية والطائفية مجرد تهمة توجه لأصحابها، بل إن هذه النزاعات تنتهي باختفاء حماتها ودعاتها والدول التي قامت على أساسها. لكن هذا لا يعني أن هذه الانتماءات قد انتهت، أو ستنتهي قريبا، حيث إن المسألة ثقافية في الأصل. ونظرا لكونها كذلك، فإنه لا يمكن التخلص منها فورا أو بنص قانوني، أو بقرار إداري، حيث يتطلب الأمر عملا ثقافيا مضنيا طويلا يفضي إلى القطيعة معها. فقد يقطع بعض الأفراد مع هذه النزعات، لكن ما يزال مستبعدا أن تحدث الشعوب قطيعة معها. فمن الممكن أن يتخلص الإنسان من اعتناق القومية إيديولوجيا وسياسيا، لكن لا يمكنه التخلص من انتمائه إلى لغة وشعب وثقافة بعينهما بشكل فوري، فالأمران يختلفان تماما، لكن الأخير منهما تفرضه عليه الطبيعة والتاريخ والواقع…
عندما نتأمل تاريخ المجتمع المغربي نجد أنه قد تكون بشريا عبر تاريخه الطويل من أقوام متعددة الأصول واللغات والثقافات. لذلك، لا يمكن النظر إلى الشعب المغربي من زاوية عرقية، كما يفعل دعاة القومية العربية، أو أية قومية أخري التي تستند إلى نظرة عرقية جعلتها تسقط في ممارسة نوع من العنصرية. هكذا، يبدو لي منطقيا أنه عندما يتعلق الأمر بالمجتمع المغربي يجب أن نتحدث عن مفهوم “السلالة التاريخية” الذي ينطبق كثيرا على هذا المجتمع، كما ينطبق في الآن نفسه على أغلبية المجتمعات المعاصرة؛ فالمجتمع المغربي مركب فريد من العرب بأنواعهم، والأمازيغ على أشكالهم، واليهود والمسيحيين…
وقد انصهر هؤلاء جميعهم في بعضهم البعض عبر تاريخ هذا المجتمع، فصاروا يشكلون “سلالة تاريخية” واحدة، فيما وراء الأعراق والديانات والطوائف واللغات والثقافات. فالعرب يشكلون ضمن هذا المزيج جزءا لا كلاً، وكذلك الأمر بالنسبة للأمازيغ وغيرهم. وهذا ما يستوجب التخلص من مفهوم “الأقليات”، واعتماد مفهوم “تعدد الهويات” أو ” الهوية المتعددة”. ومن أجل ذلك، يجب القول بانتساب الشعب إلى الأرض التي يعيش فيها، وليس إلى لغته أو دينه، أو طائفته، أو عرقه. فسكان المغرب هم الشعب المغربي، لا فرق فيه بين فرد أو آخر، بين من ينتمي إلى أحد أصوله العرقية وبين من ينتمي إلى أصل إثني آخر، بين من يتكلم هذه اللغة وبين من يتكلم أخرى. فالشعب في سائر الأحوال يجب أن يبقى واحدا موحدا. لذلك، يجب أن تكون المواطنة هي الأساس والأصل، لا الانتماء المذهبي أو الديني أو الِعرقي أو الثقافي أو اللغوي…
لقد شكلت النزعة القومية عموما، كما نظر لها كبار منظريها، مشكلة كبرى يجب التخلص منها؛ حيث قدمت هذه التنظيرات ” القومية العربية” أو غيرها من القوميات الأخرى، باعتبارها تشبه نوعا من الدعوة الدينية، لأنها تزعم أنها تمتلك الحقيقة المطلقة بمفردها، وأنه يجب تجسيد تلك الحقيقة في توحيد بلدان الشرق الأوسط والمغرب العربي، وفي بناء الدولة الواحدة في هذه المنطقة. وأظن أن هذه الفكرة تحجب، بوعي أو بدون وعي، حقائق التاريخ والواقع التي تدل على أن هناك عناصر كبرى متعددة ومتنوعة ومتباينة تشكل المجتمع الشرق أوسطي والمغاربي معا، مما ُيلزمنا بأن نكون فكريا وإنسانيا ضد كل نزعة قبلية أو قومية أو لغوية أو عرقية أو طائفية تلغي التعدد والتنوع والاختلاف في هذه المنطقة، لأنها تنظر إلى ما عداها من الجماعات المكونة للمجتمع، والطوائف واللغات، بوصفها “أقليات”، وتسعى في نهاية المطاف إلى الهيمنة عليها. لذلك، أرفض هذه الكلمة الأخيرة بدورها. فعناصر المجتمع، سواء كانت مسلمة أو يهودية، أو مسيحية، أو عربية، أو أمازيغية، أو غيرها، بصرف النظر عن حجمهما داخل المجتمع، هي مكونات تنحدر من تاريخ مجتمعات الشرق الأوسط والمغرب معا. فكل مكونات هذه المنطقة هي عناصر تكوينية في المجتمع، ولا يمكن النظر إلى بعضها بوصفه أصولا وبعضها الآخر باعتباره أقليات. والعروبة نفسها هي جزء من هذا التكوين وليست كله. تبعا لذلك، فنظرية القومية العربية هي نظرية تخفي الواقع المتعدد وتحجبه وتختزله وتلغيه، ما يجعلها تجسد نوعا من الإقصاء والإبعاد، وهو ما يدفع الكثيرين إلى وصفها بكونها تتسم بالعنصرية…
لا تسيء النزعات القبلية والعرقية والقومية والطائفية المتطرفة إلى الآخر فقط، بل وكذلك تنسف ذاتها، لأن الذات من خلال رفضها للآخر فإنها هي ترفض نفسها وتعزلها، ومن خلال معاداته فإنها تعادي ذاتها، لأن عدم الاعتراف بالآخر هو إنكار للذات، وجعلُها ضد التطور والتقدم نتيجة رفضها الانفتاح على الآخر.
إضافة إلى ذلك، فأغلبية الأحزاب القومية والطائفية وغيرها، من أحزاب وتنظيمات المجتمع في هذه المنطقة بجميع أشكالها، هي تنظيمات دينية. وأرى أن كل مشاكل العمل السياسي والاجتماعي في مجتمعات هذه المنطقة تكمن في هذه العلة الكبرى. ومردُّها انغلاق رؤى تلك الأحزاب والتنظيمات وعدم انفتاحها، ما يحول دون تطورها؛ فأفكارها مجرد طقوس و ُبكائيات وتراتيل، وزعاماتها لم تُعد النظر في رؤاها من أجل تكييفها مع التطورات الاجتماعية والعلمية، والتحولات العالمية. بدل ذلك، تحولت إلى أديان ومذاهب تعتقد أن على الواقع أن يتكيف معها هي لا العكس، لأنها، حسب توهّمها، هي من تمتلك الحقيقة المطلقة، ما يجعلها ترفض التغير، رغم أن الواقع والعالم يتغيران من حولها.
عندما نرجع إلى تاريخ البشرية نجد أن كل النزعات القومية قد فتكت بمجتمعاتها وأفضت إلى انتحار دعاتها وحماتها. وللتدليل على ذلك، يكفي أن نأخذ مثال هتلر الذي تسبب في خراب العالم، وكان سببا في نهاية النازية والفاشية معا، وبالتالي فالتجربتان الألمانية النازية والإيطالية الفاشية تؤكدان صحة هذه الحقيقية، حيث تدلان على أن النزعة القومية تتضمن أخطارا كبيرة قد تأتي على مجتمعاتها وعلى الانظمة السياسية التي تنهض عليها…

وإذا انتقلنا إلى التاريخ الحديث لمنطقة الشرق الأوسط، وجدنا أن الأنظمة القومجية العربية قد قادتها أوهامها إلى التسلط على مجتمعاتها، فانتهت بتفتيتها، وبانتحار الأنظمة السياسية القومجية. فكل المآسي التي عاشتها وتعيشها بلدان العراق وسوريا وليبيا… ناجمة عن أن الأنظمة السياسية فيها قد اعتنقت النزعة القومجية العربية وغالت في ذلك. ونظرا لتأثيرات تركة هواري بومدين في الثقافية السلفية القومجية، فإن حكام الجزائر اليوم يسيرون على النهج التوسعي للنزعة القومجية، ما قد يؤدي إلى إلحاق أضرار كبيرة بهذا البلد الشقيق، بل إنه قد يفضي إلى خراب جنرالات الجزائر، الذين لا همّ لهم سوى التوسع على حساب جيرانهم شرقا وغربا وجنوبا. النزعات القومجية تفتك بمجتمعاتها وتفضي إلى انتحار الأنظمة السياسية التي تنهض عليها.