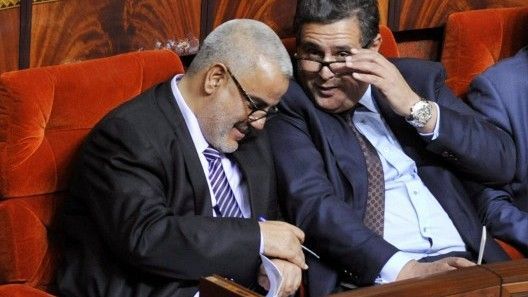زياد الأتاسي
في عام 1511 خرج للمرة الأولى من المطبعة كتاب “في مدح الجنون” لـ ايراسموس دي روتردام. وقد أثر هذا العمل أيما تأثير في الأدب الغربي. إنه يروي، لاذعًا، وناقدًا، ومتوافقًا مع تقاليد عصر النهضة، ولادةَ إلهة الجنون من الإلهين “بلوتو” و“هيبي”. ويحكي أيضًا عن رفقائها: التملق، وحب الذات، والخبل، والكسل، ورخاوة العيش، والنسيان، والشهوانية. الإلهة نفسها هي التي تترنم بمدائحها، فتتحدث عن الأطفال والزواج، وعن الصداقة، وعن أنه بفضل الجنون وحده، يمكن لأية رابطة إنسانية أن تكون محتملة (بدون أن نتمكن من أن ننفي عنها العقل، بسبب وجاهة حججها). لكن بعض المقاطع الأكثر إثارة للاهتمام من هذا العمل هي تلك المخصصة للملوك، والأمراء، والأساقفة، إذ يوجه انتقادًا حادًا إلى لين عيشهم.
يقول ايراسموس إنّ الأمراء والملوك يعبدون الجنون، إذ لو أنّهم حكموا حكمًا صائبًا بشأن الأعباء التي ينبغي أن يتحملوها، فإن حياتهم لن تكون إلا حزينة وبائسة. فكون المرء حاكمًا يقتضي منه العمل ليل نهار في سبيل الصالح العام، وعدم الانحراف عن القوانين، والعلم بنزاهة عمَّاله، وتَذَكُّرَ أن الجميع ينظرون إليه؛ وأن الحاكم، بعاداته، يمكن أن يؤثّر تأثيرًا مفيدًا في الجميع. ولو كان هؤلاء أمراء حكماء، لما استغرقوا في النوم ولا استطابوا الطعام على موائدهم. لكن، نظرًا لكونهم أسرى الجنون في أعماقهم، فإنهم يتركون كل شيء بيد القدر وبأيدي مستشاريهم، متفرغين للكسل، وللسعي وراء مسراتهم، أعداءً للمعرفة، مناهضين للحريّة والحقيقة، ساعين وراء منفعتهم الخاصة وحسب. كل زخارفهم وتيجانهم وصولجاناتهم وحللهم الأرجوانية ما هي إلا محاكاة ساخرة لما هم عليه الأقوياء حقًا.
الشيء ذاته يقوله عن الكرادلة والأساقفة. فإثر عودته من روما، ممتعضًا تمامًا من الفجور الذي استحوذ على الكنيسة الكاثوليكية، ستفتح كتابات ايراسموس، في واقع الأمر، الطريق إلى حد ما أمام الإصلاح البروتستانتي. لقد مضى زمن، كما يقول، والبابوات والأساقفة يقلدون الملوك والمرازبة. الرعاة يتغذون جيدًا ويتركون القطيع بين يدي المسيح. ناسين ما تعنيه كلمة أسقف (obispo) أي “المراقبة، الحراسة”. يرون العقيدة غامضة، إلا أن رؤيتهم تصبح حادةً عندما يتوجهون لاغتنام المال. يقول البابوات إنهم نواب المسيح، لكنهم لو قلدوا فقره وتعاليمه، كما تقول إلهة الجنون، فإن بوسعهم أن يكونوا بائسين وحسب. وبقيامهم بذلك، سيفقدون في كثير من الأحيان الكثير من الامتيازات، عابرين بالضرورة من الثراء إلى الصّيام، عبيدًا من أجل التّهجّد والدّراسة. وإنهم، إضافة إلى ذلك، ليرفعون السلاح ويتاجرون بقوانين المسيح، ولا يتورعون عن إراقة الدم في العديد من الأحيان إن لزم ذلك لتأمين سيادتهم وهيمنتهم.
يُرى في هذا النقد اللاذع الذي ينطوي عليه “في مديح الجنون” تفكيرٌ كان قد أخذ يشق طريقه، بشيء من الخجل؛ فقد بدأ التمييز بين ما ينبغي أن يكون عليه الحاكم وما هو واقع فعلًا. وبخلاف كتابات القديس توماس الأكويني، ما عاد الحديث فقط عن الأمير المسيحي الطيب وإنما، على غرار ميكيافيللي أو توماس مور، عن كيف هم الحكام على أرض الواقع. وما يبينه ايراسموس هو أنه إذا كان الأمراء والبابوات ما ينبغي أن يكونوا عليه وفقًا لمقامهم، فإن بوسعهم الكلام فقط عن مدى الألم الذي تستجلبه أعمالهم، أي أن أحدًا لن يرغب بالسلطة إذا ما كان متمتعًا بالعقل السليم. وعليه، يستشف من هنا أن وجود أشخاص يتحملون عبء السلطة ويبتهجون به هو أمر ممكن فقط لأنهم حمقى ومجانين. ولقول ذلك بأسلوب آخر، إن ممارسة السلطة تتطلب درجة من الاعتلال النفسي، أو سلوكيات تؤدي إلى عدم التوازن العقلي. فإما أن السلطة تصيب بالجنون أو أن أولئك الذين هم أكثر جنونًا هم الذين يصلون إليها.
لا داعي للتعمق في التاريخ للعثور على كل نوع من أنواع الدراسات التي تعزز أطروحة “ايراسموس”. عادة ما يجري الحديث عن “كاليغولا”، الامبراطور الروماني، بوصفه واحداً من الأمثلة الأكثر اكتمالاً، الذي قال عنه “سينيكا” إن النظر إلى عينيه كان كافيًا لكي تُرَى صنائعه. وفيما يتجاوز أسطورة تسمية الامبراطور لحصانه عضوًا في مجلس الشيوخ -الأمر الذي قد لا يقول شيئًا جيدًا عن المنصب أو عن المرشحين البدلاء- فإن “كاليغولا” كان يؤكد أنه “جوبيتر” وقد بعث حيًا. وفي الثامنة والعشرين من عمره اغتيل وبقي اسمه للأبد مقترناً بجنون العظمة المرتبط بالعرش. تقدِّمُ السلطة المطلقة للأباطرة المزيد من الأمثلة عن الجنون، من “نيرون” إلى “كومودوس”، حالاتٍ وصلت إلى أيامنا لكونها منقوشة على الحجر، وليس لأن المزاربة والطغاة السابقين، من فارس إلى موريطانيا الطنجية، لم يكونوا مماثلين. وفي حالات أقرب عهدًا لدينا “أوتو” دوق بافاريا و”لويس الثاني”، اللذان انتهى أمرهما إلى العلاج الطبي، أو “خوانا المجنونة” في قشتالة أو القيصر “ايڤان الرهيب”، اللذان يقال إنهما أصيبا بالبارانويا… وصولاً إلى “جون الأول” ملك انكلترا أو “كارلوس الثاني” ملك اسبانيا، الملقب بالمسحور، اللذين كانت لهما أفعال من ليس في كامل قواه العقلية.
علي أية حال، ينبغي عدم الخلط بين الجنون في الغايات والسرعة في الوسائل. فمن أي حاكم يُتَوَقَّع الحد الأدنى من العقلانية الأداتية، أي تلك التي توجه أفعاله لتحقيق أهدافه السياسية. وعلى مدى التاريخ حمل ذلك معه فظاعات رهيبة، من صب البارثيين للذهب المصهور في فم “كراسوس” إلى عمليات البتر بحق المحرومين من العرش البيزنطي، أو تطهير عائلات الخصوم. حتى أكبر الفظاعات البشرية التي ارتكبت على الإطلاق، أي الهولوكست، نفذت بعقلانية دقيقة. على العكس من ذلك، إن الجنون هو فساد في أصل الغايات، لكن هذا لا يعني أن يشترط فيه التنفيذ التدقيق. أو ليس دائمًا على الأقل. إن ما ينطوي عليه الجنون هو شيء أكثر رعبًا: غياب التوقع. وهذا ما يتم التشجيع عليه، في كثير من الأحيان، من قبل السلطة نفسها، وهو ما يولِّدُ أكبر قدر من التوتر في أوساط الحاشية والشعب. إن نقيض القانون هو ترك كل شيء بين يدي العفريت الصغير الذي يضيء في عيون الملك المجنون.
الطغاة المعاصرون أيضًا يلجأون إلى هذا بجرعات معتدلة إلى هذا الحد أو ذاك. فالديكتاتوريات ذات الصبغة الشخصية (على النقيض من تلك التي يهيمن فيها حزب واحد أو الملكية)، على سبيل المثال، تطبقه من خلال أشكال عبادة الشخصية. صور ضخمة في كل الساحات، مكبرات صوت تشدو بمدح اسم الزعيم المحبوب، تسجيلات وصور تذكارية، احتفالات خاصة بعيد ميلاده، وتمجيد للديكتاتور بوصفه محرك العالم أو حامل المطر؛ إنه عمل مجنون عظمة حقيقي ذي سلطات تامة، لجأوا إليه، وما زالوا يلجأون، من ماو إلى لينين، ومن الأسد إلى كيم جونغ-اون. إنهم كاليغولات صغار غارقون بالأنا والجنون، على الرغم من توفر نية وقصد لديهم من وراء ذلك.
أما بالنسبة للطاغية العابد لذاته، فإن عبادة شخصه هي شيء يمكن أن ينفع في تكوين مؤمنين حقيقيين بالقضية، وهو شيء مفيدٌ دائمًا. من الممكن أن يفضي تكرار فضائل الزعيم تكرارًا لا نهاية له إلى أن يوجد من يقتنع به حقًا، ولا سيما من خلال وسائل الإعلام المسيطر عليها كما ينبغي. إن جنون العظمة هو أساس البروباغندا التي يقوم عليها النظام. لكن الفائدة الرئيسية لعبادة الشخصية هي بناء حواجز إضافية أمام المعارضة بحيث لا تتمكن من التنسيق فيما بينها ضد النظام. فمن الصعوبة بمكان أن يكون بمستطاع أحد أن ينظم نفسه، حتى من منظور سيكولوجي، تحت أعين الطاغية. في مقابل ذلك، هنالك دائمًا تلك التكاليف المقترنة بتوجب الخروج إلى العرض التالي والتصفيق بالقوة اللازمة، وتقبيل قدمي تمثال الديكتاتور بالقوة الكافية. وذلك كله، الذي يمزجه الزعيم بشرطة سرية شديدة وألف طريقة لتصفية مناوئيه، يفاقم الخوف من السلطة الاعتباطية… من هذا الملك المجنون الذي يسيطر على البلاد.
دعونا الآن نتجه نحو السياسي في أية ديموقراطية. عندما يكون سياسيونا في بيئة محيطة شديدة التغير كما هو الحال الآن، شديدي الانكشاف أمام وسائل الإعلام بدون وقت حتى للتفكير (لا وقت إلا لردود الأفعال فقط)، فإن السؤال ذا الصلة هو ما إذا كان لمن يصل إلى المنصب بالفعل بعض ملامح الاعتلال النفسي أو أن حلة السلطة الأرجوانية ذاتها هي التي تفقد الصواب. ثمة دراسات تشير إلى أن معظم رؤوساء الولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال، كانت لديهم ملامح معتل نفسي، حتى في الحقبة التي سبقت ترامب. من المفهوم أن نتخيل أن امرءً طموحاً بما فيه الكفاية للدخول في معترك السياسة ينبغي أن يتمتع بخصال مميزة كطلاقة اللسان أو الثقة بالنفس. لكن، عادةً ما يتزاوج الطموح مع الدناءة والاعتلال الاجتماعي وتصور عن الأشخاص بوصفهم وسائل وليس غايات بحد ذاتها. إن الضغوط على الروح شديدة إلى الحد الذي لا يمكن إلا أن تسبب بعض الانكسار.
لنفكر للحظة كيف سيشعر زعيم حزب ملاحق بالمؤامرات الداخلية، في صراع مستمر مع خصومه من التشكيلات الأخرى، محاطًا بالمتملقين وبتشويه سمعته في شبكات التواصل الاجتماعية ووسائل الإعلام، وشاعرًا كل يوم بالمزيد من الوحدة والعزلة. إن السلطة مفرمة لا هوادة فيها تشيب الصدغين وتفسد العقل. فلا عجب أن تنغلق دائرتهم في النهاية ويصيبهم الجنون. كلما كبرت السلطة، وكلما زاد القرب من كاليسي (Khaleesi)، ازداد الضغط عليهم. بل إنهم ليسوا متيقنين مما إذا كانوا سيستمرون في المنصب، ويتشبثون أكثر فأكثر وبقوة أكبر ببهارج السلطة وبمتعتها الجامحة. الفكر الحر يحتضر، ترتص الصفوف، والابتسامات قسرية. في حياتهم الخاصة، يفزعون إلى الكحول، أو المخدرات، أو الجنس، شيء يمكن أن يذكرهم بأنهم ما زالوا أحياء على نحو من الأنحاء. وهكذا يصبح الجنون درعهم الوحيد.
كان ماكس فيبر يقول إن مهنة السياسي تقتضي الشغف، والمسؤولية، والاعتدال. الشغف من أجل أن يكون له محرك من داخله يحفز أعماله؛ والمسؤولية من أجل تحمل عبء تداعيات هذه الأعمال؛ والاعتدال من أجل الإبقاء على بعض المسافة من ممارسة السلطة.
إن الأخير على الأرجح هو أكثر ما يمس بالعلاقة مع الجنون، وحيث يرى فيبر فساد عصره. إنه يرى السياسي المفتقر إلى الطموح النقي شيئًا سيئًا كان ينمو باطراد في ألمانيا بين الحربين. ويبين جيدًا كيف أن النرجسية في السياسة تؤدي إلى فتح الطريق بوجه كل الشرور. واليوم، إن من الصعوبة بمكان عدم التفكير بأن الجنون والسياسة هما وجهان لعملة واحدة، وحيث اجتياز (اختبار) تقنيٍّ نفسي سيكون أمرًا غير قابل للتفكير فيه في مجلس حكومي.
ينتهي الجنون، الذي تفرضه طبيعة السلطة، بقتل العنصر الأخير المتبقي لممارستها: التعاطف. إنها اللحظة التي يدور فيها الكل حول أهواء تلك الشخصية التي تتحرك بالدوافع، التي تسعى بكل طاقتها وجهدها لتلبيتها. ما عادت توجد قدرة على الشعور بالآخر، بل شعور بالذات فقط.
من الطبيعي أن القدماء أوصوا بالهرب من كأس السياسة إلى ذلك الذي يتطلع إلى إنقاذ الروح؛ إذ ينبغي أن يكون بالمرء مس من الجنون لممارسة السياسة. فطوبى لأولئك الذين يمارسونها ولهم مسكة من عقل.