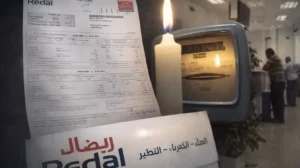في قرار قضائي بالغ الأهمية، قضت المحكمة الدستورية بعدم مطابقة مجموعة من المواد الواردة في مشروع قانون المسطرة المدنية للدستور المغربي، مُحدثة بذلك زلزالاً تشريعياً يُعيد فتح النقاش حول سلامة الهندسة القانونية التي تقودها وزارة العدل في الولاية الحكومية الحالية. القرار الذي صدر تحت رقم 255/25 بتاريخ 4 غشت 2025، شكّل نقطة تحول في مسار هذا النص التشريعي المثير للجدل، والذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس النواب في قراءة ثانية وسط أجواء متوترة ومقاطعة واضحة من المعارضة الحقوقية والمهنية.
ما الذي يعنيه هذا القرار في عمقه السياسي والدستوري؟ ولماذا تُطرح علامات استفهام حقيقية حول طريقة إنتاج القوانين المرتبطة بحقوق المتقاضين وضمانات العدالة؟
أول ما يُلاحظ هو أن عدداً من المواد الجوهرية – مثل المادة 84 والمادتين 408 و410 وغيرهما – تعطي سلطات غير مقيدة للوزير المكلف بالعدل، خاصة في مسائل تتعلق بالإحالة بدعوى التشكك في القضاة، وهي صلاحيات تمس صميم مبدأ الفصل بين السلط، وتشكل تضييقاً ضمنياً على استقلالية القضاء. فكيف يُعقل أن يملك الوزير التنفيذي حق الطعن في أداء السلطة القضائية بدعوى “الشك المشروع”، بينما الأصل أن هذا الحق لا يُمارس إلا ضمن آليات دقيقة تكفل التوازن الدستوري؟
ثم تأتي الفقرة المتعلقة بالتبليغ – كما في المادة 84 – التي تسمح بإبلاغ أشخاص دون سن الرشد القانوني بمضامين قضائية، وهو ما يُعتبر انتهاكاً لقرينة الوعي القانوني والإدراك الحقوقي، بل ويفتح الباب أمام الطعن في عدالة الإجراءات من منطلقات شكلية وجوهرية معاً.
الأكثر خطورة من ذلك، المادة 375 التي تحرم المتقاضي من الطعن بالنقض في القضايا التي تقل قيمتها عن 30 ألف درهم، وكذا المادة 30 التي تمنع الاستئناف في الملفات التي تقل عن 10 آلاف درهم. هذا التوجه لا يعني سوى أمر واحد: تكريس عدالة انتقائية على أساس القدرة المادية، وهو ما يناقض روح الفصل 118 من دستور 2011، الذي ينص صراحة على أن “حق التقاضي مضمون لكل شخص”، بغض النظر عن وضعه الاجتماعي أو المالي.
هذه المواد تثير قلقًا مضاعفًا لكونها لا تنفصل عن سياق عام يتميز بتراجع منسوب الثقة في المنظومة القضائية، وانطباع متنامٍ بوجود رغبة في “ترشيد العدالة” على حساب تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون. والمؤسف أن المشروع تم تمريره في البرلمان بأغلبية عددية (47 صوتًا فقط من أصل 395)، وهو ما يطرح سؤال الشرعية السياسية والديمقراطية لهذا النص، ويكشف عجزًا مقلقًا في التفاعل الجدي مع المذكرات التحذيرية التي أصدرتها المؤسسات الحقوقية، وعلى رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ومن المفارقات الصارخة أن المشروع، بدل أن يعزز سلطة القضاء، يُقيد آليات تنفيذ الأحكام، كما هو الحال في المادة 502 التي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة والجماعات الترابية، ما يشكل عمليًا التفافًا على الفصل 126 من الدستور، ويُدخل المغرب في دائرة “التمييز المؤسسي” بين الإدارة والمواطن، بل ويمسّ بجاذبية الاستثمار والأمن القضائي.
الأمر لا يتعلق هنا بملاحظات تقنية، بل باختيارات سياسية مقصودة، تكشف وجود رؤية بيروقراطية تُريد ضبط العدالة من خارج منطقها الدستوري. لهذا كان من الطبيعي أن يخرج صوت القضاة والمحامين والحقوقيين محذرًا من أن مشروع المسطرة المدنية، في صيغته المصادق عليها، لا يُمثّل تطورًا في المسار الحقوقي، بل انتكاسة قانونية تضرب أحد آخر معاقل العدالة الاجتماعية والدستورية.
ختامًا، فإن قرار المحكمة الدستورية يُعد انتصارًا للنص الدستوري على الحسابات السياسية الضيقة، ويؤكد أن البناء التشريعي يجب أن يظل خاضعًا لميزان الرقابة الحقوقية والقيمية، لا لتوازنات الأغلبية الصامتة أو التحالفات الظرفية داخل البرلمان.
إن الإصلاح الحقيقي للمسطرة المدنية لا يمر عبر تقليص حقوق المتقاضين، بل عبر تمكينهم، وتحصين العدالة من أي هيمنة سياسية أو تنفيذية. وعلى الحكومة أن تدرك – ولو متأخرة – أن دستور 2011 لم يكن مجرد إعلان نوايا، بل تعاقدًا سياسيًا واجتماعيًا يُحتِّم احترامه في كل مشروع قانون، وإلا فإن شرعية النصوص تنهار من داخلها.